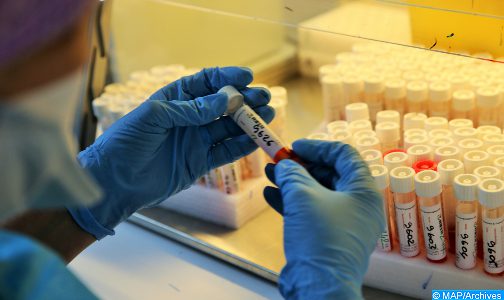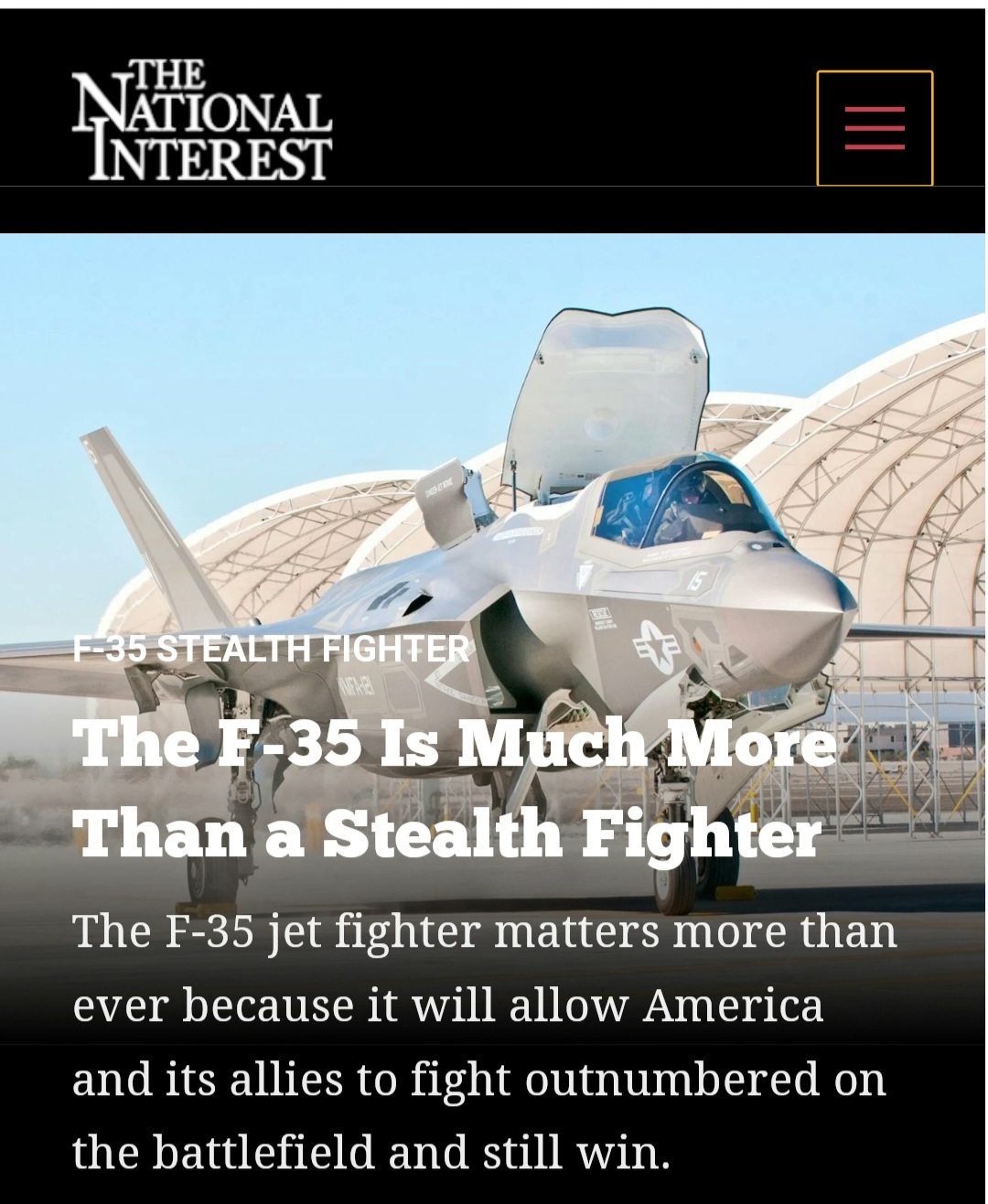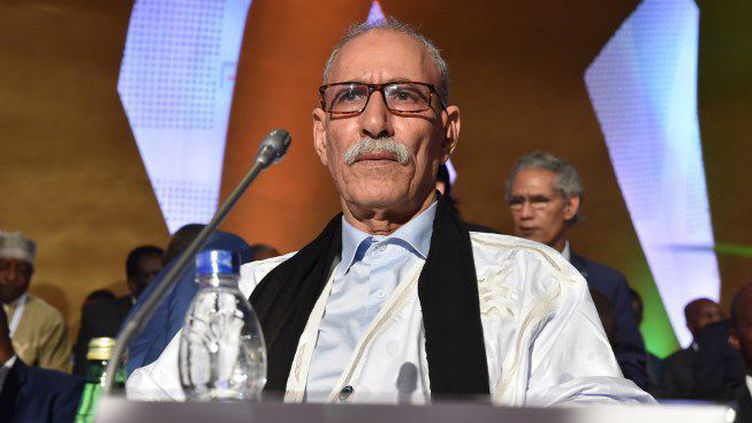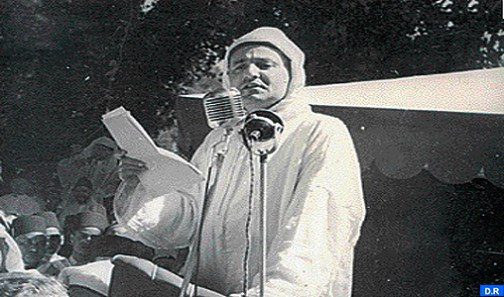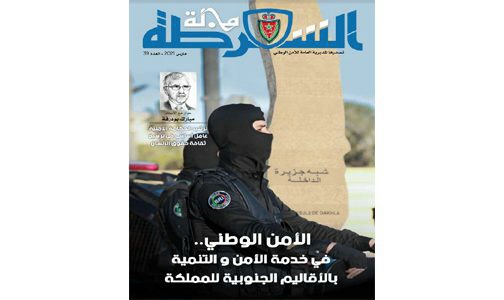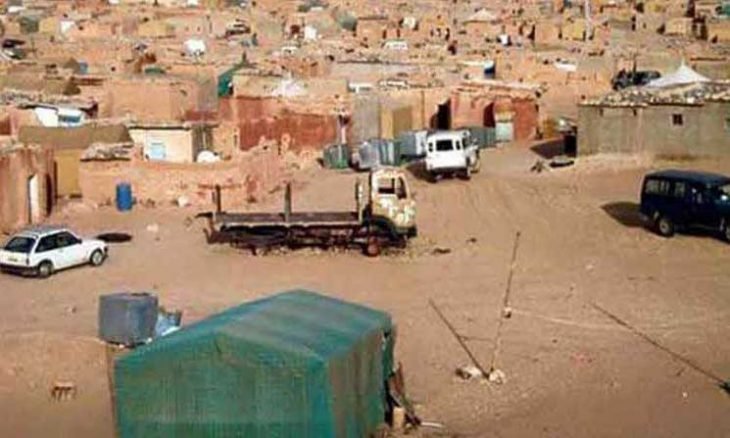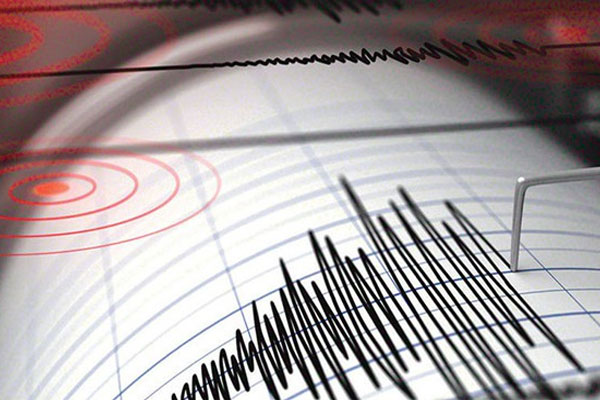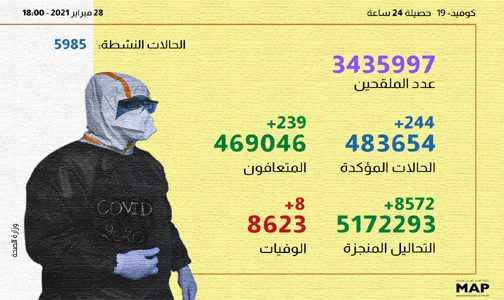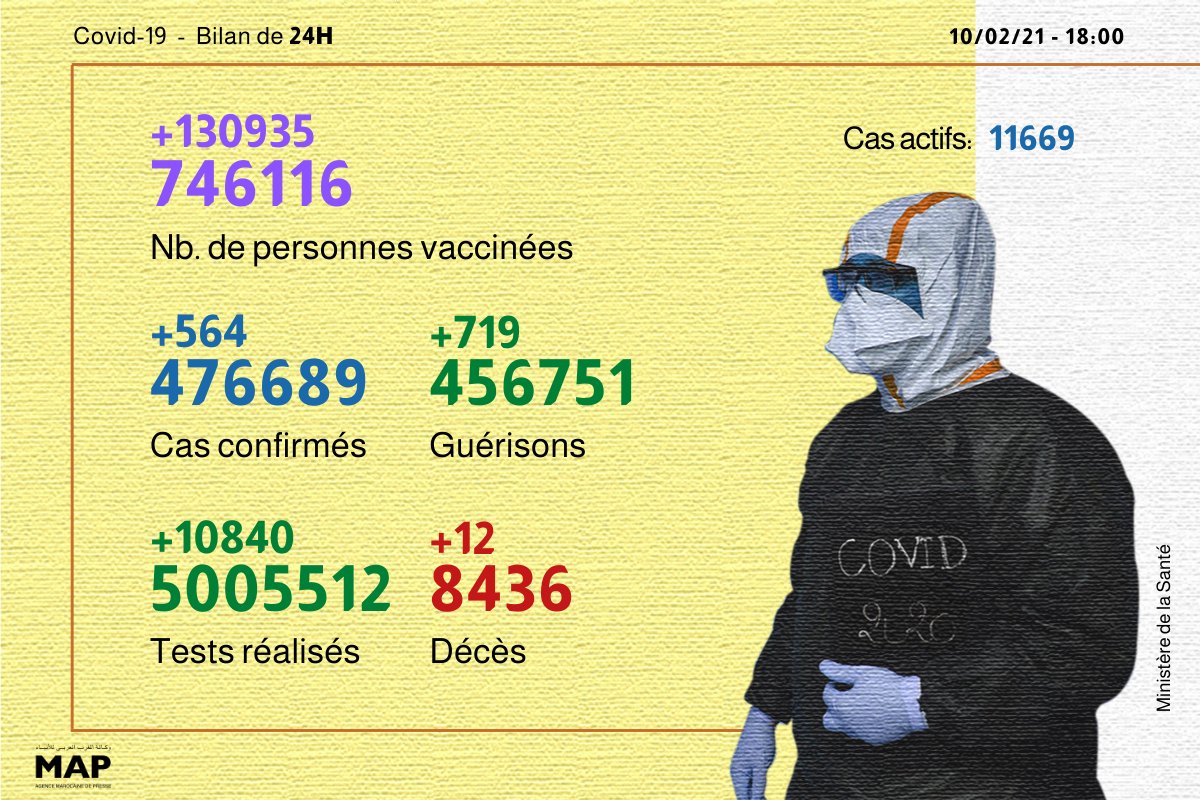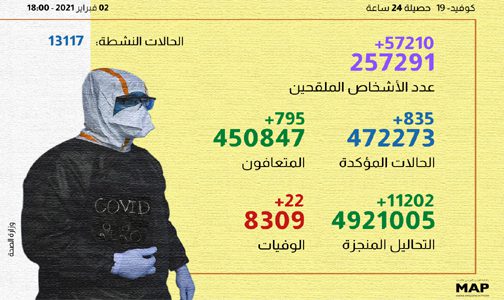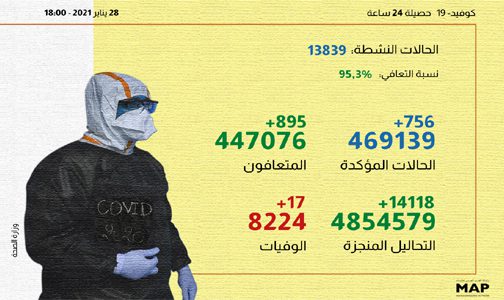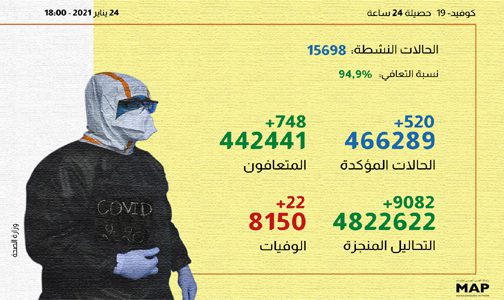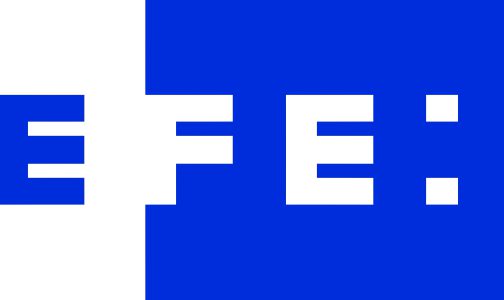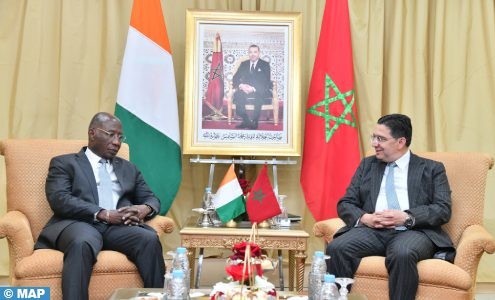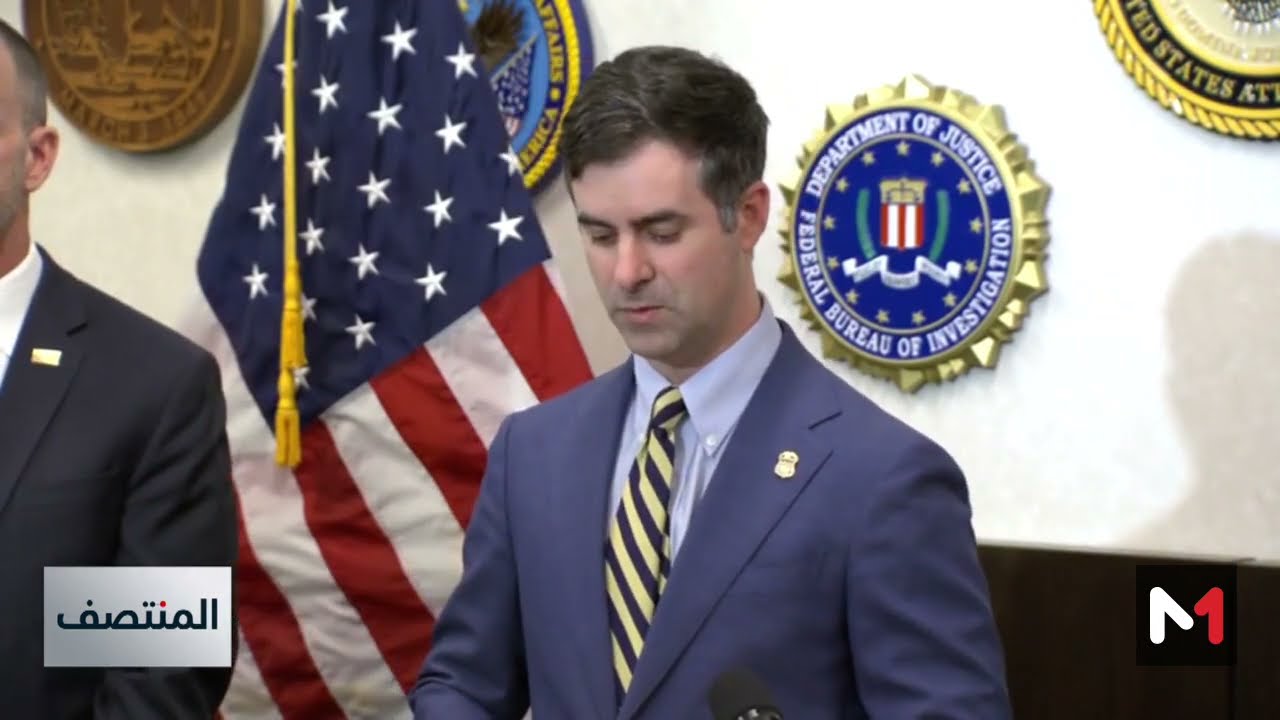عذراً أيتها الريشة فلم أخطط على بياض الورق بحروف من ذهب لأناملي الوردية وفشلت كل محاولاتي في فك خيوط لغز جريمة نكراء اقترفها الوطن في حق أهل قرية بعيدة منهم وقريبة إلى قلبي. اصبري، فأنت مبتلية بآذان صماء تأبه السماع إليك وتعشق التفرج على حالك من خلف الشاشة ومن تحت البطانيات. فهم يبتسمون لهمومك ويحملونها شعارا لحملاتهم رغبة في كرسي عابر على حساب وجوه بريئة تجهل معنى السياسة والأحزاب وتسعد لدى سماع كلمة الخبز على أنغام وتر العود.
عذرا أيها القلم فلم تفلح ذاكرتي في وصف اشتداد سنوات الابتدائي بعسر إملاقها، ولا في نعت حال بلدة تأمل في التغيير عند كل موعد انتخابي. لكن لا تيأس فبنور العلم ترى أسراب الطيور وقد عادت لتشدو ونور الشمس، وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان شجر الفقر والتعاسة لتشعل فتيل شموع أمل لا تخلوا متاهاته من أشواك .
في القرية المعزولة حيث أقطن نتابع الدراسة إلى حدود السنة السادسة ابتدائي، أي ما يعادل سن الثانية عشر بلغة الأرقام. وبعد ذلك تأتي مرحلة أشبه بشن مغامرات غير محمودة في عالم التجديف وفي بحر الظلمات نحو ثخوم العدم. فترة الابتدائي ورغم ظروفها الصعبة لم تكن شبيهة سنوات الإعدادية لأن رأفة الأم بعد العودة من حجرة الدرس تنسينا مرارة الأوضاع الاجتماعية والطبيعية.
عند الرجوع من المدرسة نلتف حول نار الخشب. يؤنسنا البرد في انتظار رغيف خبز من قمح الكرامة، ونحن نستمع لحكايات الأم الأسطورية: خرافات محبوكة من نسيج خيال البدو، تتناول تيماتها الوحوش كمكون اجتماعي ومغامرات أدب الرحلة.
وحتى لا أتيه في قصص جحا وحمار البخيل. دعوني أعود بكم إلى مرحلة الاعدادية الرهيبة. كيف لا وهي مرحلة الاعتماد على النفس، حيث يكون التلميذ قد ترك أباه ورغيف أمه المطهو فوق لهيب خشب جلبته الأمهات فوق ظهورهن متحملين كل المتاعب، لأن الحصول على قنينة غاز كان أشبه بمتابعة الدراسة.
غادرت البلدة في سن الثانية عشر، لترغمني الحياة على أن أصبح رجلا قبل الآوان رغم أن الحالة الفيزيونومية والنفسية لا تسمحان. ودعت قريتي المعزولة لأصطدم بعالم يشعرني بأني المنعزل عن وطن أحبه، لكنه حب من طرف واحد فوطني لا يحبني !!!
أصرخ صرخة الضعيف لحاله، وأقوم بدور النقابي في حوارات مباشرة لأسمع العالم همي وأساطير دمعتي وأقول له من السبب؟ كيف يعقل لطفل صغير تحمل المسؤولية في سن الثانية عشر عاما؟ سن ما يزال يحتاج فيه لحنان الأم والأب واللعب… لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
فإما أن أتحمل الأوضاع الموحشة وإما أن أبقى في بلدتي فيكون مصيري أشبه بحال أصدقائي الذين غادروا كراسي المدرسة في سن مبكرة وهم الآن يحتسون كؤوس المرارة. إذن فلا مناص… فإما الاستسلام بدعوى الظروف القاسية، وإما التضحية رغبة في مستقبل مجهول. أنا كنت من الفئة الثانية التي لم تكن تفضل الاستسلام.
متابعة الدراسة في الإعدادية وفي مكان بعيد عن مسقط رأسك يحتاج بالضرورة إلى مسكن ومأكل ومشرب… حينها كان أبي يعمل بالدار البيضاء كنادل في مقهى لضمان عيش الأسرة. وكان جدي يقوم بدور ولي الأمر. لهذا تكلف بأعباء التسجيل والبحث عن الإقامة. وما زلت أتذكر اليوم الأول من سلسلة هذه الأحداث المشئومة.
البداية كانت مع رحلة سفر إلى مدينة “دمنات” على الساعة الثالثة صباحا على متن سيارة “لاندروفيل” فهي الوحيدة التي تستطيع تحمل مأساة طريق بلدتي غير المعبدة. ليلة لم تكن كباقي الليالي…ليلة بكاء ونحيب بامتياز، وكان لأمي الحنونة النصيب الأوفر…بكاء الإحساس بالمسؤولية في وقت مبكر.
عندما دقت ساعة المغادرة ودعتني وهي تذرف الدموع…دموع فرضتها مفارقات المغرب العجيبة. سقطت دمعتها على خدي لتعلن حينها لحظة حزن يغمرها أمل الحصول على وظيفة حارس غابة أو طبيب أو أستاذ…لعلها تخرجهم من معاناة جبال منسية وحتى لا يكون مصيري الضياع. “ك أركاز تغرت مزيان” يعني “كن رجلا وأهتم بدراستك” كانت هذه كلمتها الأخيرة.
منحتني تفاحة حمراء اللون كعيوني من شدة البكاء وكان مذاقها مر حين اختلط بدمعتي. قبلتني وسلمتني شمعة وسط قارورة بلاستيك حتى لا يطفئها أريج الصباح ولكي أنير بها طريقي حتي الوصول إلى مكان السيارة التي ستقلنا إلى حياة الجحيم….نور خفيف في ظلمات ليل قاتم.
وصلنا بعد رحلة طويلة غاب فيها عقلي… قصدنا المؤسسة للتسجيل، فأحسست حينها أني طفل عصامي في قالب رجل علمته الحياة من دروبها ما كان يجهل. انتابني إحساس غريب أختلط فيه الخوف بالقلق والشعور بالمسؤولية والتفكير في حال أهل قريتي وفي رغيف أمي وابتسامتها المعهودة، وكنت ابتسم كلما استرجعت ذكريات اللعب مع اصدقائي وارسمها عند كل خطوة…لكن في هذا المكان فقدت كل شيء.
بعدها صاحبني جدي إلى “الداخلية” لمعرفة الوثائق المطلوبة للاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية التي يرجع لها الفضل الكبير في تكويني العلمي والأخلاقي لأن لها ضوابط خاصة يجب الالتزام بها.
الإعلان عن لائحة المستفدين من هذه الخدمة سيتأخر بعض الوقت كما جرت العادة في المؤسسات العمومية. لهذا أجبرت على البقاء عند العائلة إلى أن تحن علينا إدارة الداخلية.
احتفت بي هذه الأخيرة في اليوم الأول وما إن مرت أيام معدودات حتى بدأت في نهج سلوكات غريبة نفذ معها صبري ولم أعد قادرا على التحمل خاصة عندما وجدت حدائي داخل المرحاض ومحفظتي أمام باب المنزل.
رسالة لا تحتمل معنيين وتقول بالحرف “لم نعد نستحملك أيها الطفل الغريب”. فقررت عندها المغادرة…
(*): أستاذ اللغة الاسبانية ومترجم
https://www.facebook.com/mellouk.khalid?ref=tn_tnmn